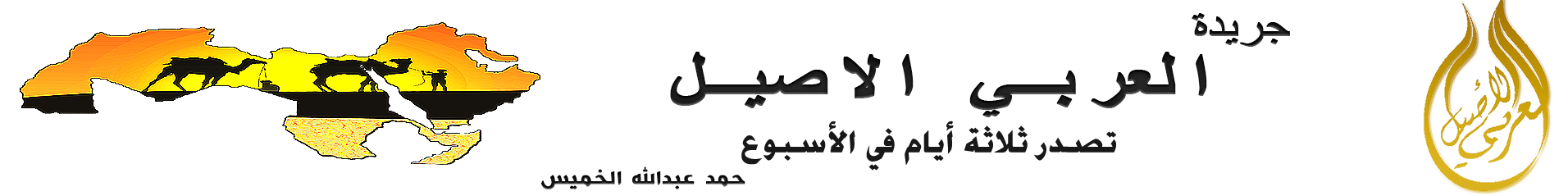التدخل الإيراني بدول المنطقة ومؤشرات سقوطه
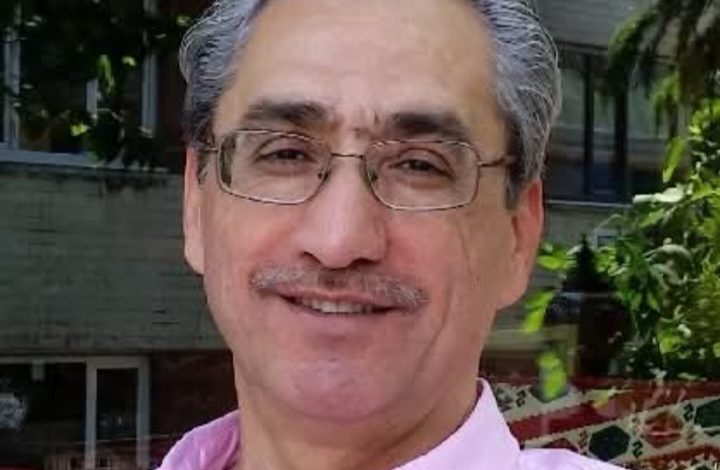
نبيل شحاده
منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة الإيرانية في عام 1979، لم يُخفِ الإمام الخميني طموحه في أن تصبح الثورة في ايران منطلقاً لمشروعٍ إقليمي عابرٍ للحدود، ليتطور الأمرُ سريعاً ويصبح تصديراً للتجربة، ودعوةً لإقامةِ حكومة عدل عالمية وفق منظوره: سنعمل على تصدير تجاربنا إلى كل مكان في العالم، ونتطلّع لأن نرى الحكومة الإسلامية قائمة في جميع البلدان، وحكومة العدل الإسلامي مستقرة في كل مكان.
ولتحقيق ذلك، بذل النظام الإيراني جهوداً كبيرة، وأنفق الأموال الطائلة لتنفيذ استراتيجية خارجية متكاملة هدفها توسيع نفوذه في منطقة الشرق الأوسط وأبعد من ذلك، حيث استندت السياسة الإيرانية داخلياً وخارجياً وبشكل أساسي إلى مبدأ ولاية الفقيه، كما جاء في مقدمة الدستور: “في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير”. هذا النص منح الخميني ومن بعده الخامنئي سلطات المهدي نفسه، وولاية عامة في جميع شؤون الأمة، وعصمَهُ من الخطأ، ومنع الاعتراض عليه، أو مساءلته ومحاسبته، مما جعل إيران دولةً فريدةً واستثنائية في العالم، تتلاشى فيها الحدود بين الدين والسياسة والرأي والقانون.
وبناءً على هذه الرؤية، أصبح تصدير الثورة واجبًا دينيًا على الدولة لتحرير مَنْ تسميهم بالمستضعفين من “الاستكبار العالمي”، وهو المصطلح الإيراني الذي يُشير إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب وحلفائهم الإقليميين، في وقت رأى مراقبون سياسيون أن هذا العداء ليس إلّا أداة لتحقيق أهداف ايران الإستراتيجية، وكسب الشرعية الإقليمية والشعبية عبر تقديم نفسها كرمز قيادي “لمحور المقاومة أو الممانعة”. ومع مرور الزمن، بدأت الحقائق تتكشّف، وأيديولوجيا “نشر العدل” تتبخّر تدريجياً لتحلّ محلّها المصالح الوطنية الإيرانية البحتة، في تناقض واضح بين الشعارات المرفوعة، والواقع المُمَارس على الأرض، وتحوّل إلهامُ الشعوبِ وتوجيهها لتبنيّ نموذج ثوري مشابه، إلى سياسةِ تدخلٍ مباشر في شؤون الدول الأخرى، بل والسيطرة عليها.
تجسّدَ المشروعُ الإيراني عملياً عبر الحرس الثوري الذي أسّسه الخميني في عام 1979، ليكون حامياً للنظام والثورة في الداخل، وذراعاً ناشطاً في الخارج، وفي ذلك قال “رسّام” المفهوم العسكري للحرس، الجنرال محسن رضائي في عام 1990، أن “الحرس الثوري هو حامل رسالة الثورة إلى العالم”. وفي نهاية الثمانينيات وُلدَ “فيلق القدس” من رحم الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي ثم خلفه قاسم سليماني، فكان الأداة الأكثر تأثيراً في ترجمة التوجّه الإيراني وإدارة العمليات الخارجية السياسية والعسكرية، مستفيداً من ميزانية سرية لا تخضع لأية رقابة.
عملت إيران أولاً على استقطاب الجماعات الشيعية في البلاد ذات الغالبية السنّية، ودفعتها لتجاوز الولاء الوطني والعبور إلى انتماء ديني صاغته إيران بما يناسب أهدافها، فرَعت مراجع دين وبنت حوزات وحسينيات، مستغلّةً ادّعاءات المظلومية التاريخية للشيعة لبناء قواعد شعبية، ومساحات جغرافية يسيطر عليها “وكلاؤها” وتشكّلُ خطوطَ دفاعٍ أمامية لأمنها، ومنصّات ضغط، فحققت إيران مجموعة من أهدافها دون تحمّل المسؤولية المباشرة عن الأفعال والجرائم التي تُرتكب.
في لبنان، لم يخف حزب الله منذ انطلاقته الارتباط المبكر بالمشروع الإيراني ولا تبنّيه ولاية الفقيه الدينية والسياسية، فنشر في عام 1985 رسالة مفتوحة إلى المستضعفين، أعلن فيها صراحة “أننا أبناء أمة حزب الله التي نَصرَ اللهُ طليعتها في إيران، نلتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه” وأضاف: “وكل واحد منّا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد”. حظي الحزب بدعم مالي وعسكري وإرشادي إيراني حوّلهُ إلى قوةٍ مسلّحة تفوّقت على الدولة اللبنانية وهيمنت عليها وتحكمت بقراراتها وسياساتها وحتى بعلاقاتها مع دول العالم، وشكّلت في جنوبِ لبنان تهديداً عسكرياً مباشراً لإسرائيل يتحكم بوقته وحجمه الإيرانيون من وراء الستارة، فكان الحزب أول وأبرز دليل عملي ومؤثر على نجاح مشروع تصدير الثورة الإيرانية.
في العراق، بدأت إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي، بتوظيف علاقاتها مع رجال دين وحركات شيعية عراقية ممن لجأوا إليها في عهد الرئيس صدّام حسين، فاحتضنت كوادرهم وعناصرهم، ووفّرت لهم التدريب والتوجيه العقائدي والدعم العسكري. ومع الغزو الأميركي عام 2003 وسقوط بغداد، شكّلت طهران المظلة الأوسع لفصائل وميليشيات مسلحة مثل “منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” ودعمتهم بالتمويل والسلاح والخبرات الميدانية للسيطرة بواسطتهم على العراق كاملاً وإبعاد السنّة والمكوّنات الأخرى عن مواقع القرار. ثم جاء ظهور تنظيم داعش ليمنح هذه الميليشيات غطاءً شرعياً بانضوائها في “الحشد الشعبي”، ودفع الحكومات العراقية لرعايته وتمويله واعتباره جزءاً من مؤسسات الدولة العسكرية. استفادت إيران من هذا المسار إلى أبعد الحدود؛ فوفّرت لنفسها نفوذاً عميقاً داخل العراق مختلطاً بالفساد والفوضى ونهب المال العام الى جانب انهيار الخدمات وتهالك البُنى التحتية، وجعلت منه ممراً برياً آمناً للمال والسلاح إلى سوريا ولبنان.
في سوريا، نسجت إيران علاقة خاصة مع النظام السوري، لمواجهة الرئيس صدام حسين تحديداً حتى أصبح حافظ الأسد حليفها العربي الوحيد خلال حربها الطويلة مع العراق (1980–1988). هذه العلاقة كانت أساسية واستراتيجية، استفاد منها الطرفان؛ عزّز حافظ الأسد موقعه الأقليمي، ونشأت في سوريا قاعدة لوجستية لا غنى عنها لإيران في مشروع التوسع وإرسال السلاح والمال أذرعها وأدواتها. ومع تولي بشار الأسد الحكم عام 2000، تعمّقت العلاقة أكثر، وسعت إيران إلى تثبيت وجودها الأمني والاقتصادي والديني في سوريا، عبر استثمارات ومشاريع مشتركة، وبناء مراكز دينية وثقافية استهدفت الأقليات الشيعية والعلوية وجذبِ بعض السنّة واغرائهم بالمال والخدمات. غير أنّ التحولَ الأبرز جاءَ مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث اضطرت ايران للتدخلِ العسكري المباشر، فأرسلت عشرات المستشارين من حرسها الثوري، ثم دفعت بحزب الله من لبنان وميليشيات عراقية وأفغانية وباكستانية للقتال إلى جانب النظام، لحماية “محورها” ومنعِ سقوط دمشق بيد المعارضة. وفّرت إيران للأسد مليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات نفطية لتأمين صموده، فيما لعب قاسم سليماني دوراً محورياً في رسم الاستراتيجية العسكرية المشتركة، التي تضمنت حصار المدن وتدميرها وقتل وتهجير أكبر عدد ممكن من السوريين السنّة لتغيير الديموغرافيا، وموازين القوى. لكن هذا التدخل لم يكن دون كلفة، إذ أنفقت الأموال الطائلة، وقدّمت قوافل طويلة من القتلى، وتعرضت لعقوبات وضغوط دولية، كما أثارت نقمة شعبية واسعة داخل سوريا حتى في أوساط الموالين للنظام. وفي الدول العربية فهم الكثيرون أن الموضوع هو أكثر من سياسي، بل هو طائفي بإمتياز.
في اليمن، وعلى الرغم من أن الحوثيين ينتمون أصلاً الى الدين الشيعي الزيدي الذي يتميّز بمفاهيم فقهية وعقائدية قريبة من السنّة، فقد قدّمت طهران دعمًا غير محدود لهم من اموال وأسلحة وتدريب ومشورة عسكرية ومعلومات استخباراتية، واستغلت ذلك لاختراق عقائدهم وطقوسهم لتتقارب مع الأثني عشرية. الايرانيون لم يخفوا علاقتهم الوثيقة بالحوثيين، فقد اعتبروا وبوقاحة أن العاصمة اليمنية صنعاء هي رابع عاصمة عربية تسقطُ في أيديهم بعد دمشق وبغداد وبيروت، وقالوا أن “ثورة الحوثيين في اليمن ما هي إلّا امتداد للثورة الخمينية”. أصبحت حركة الحوثيين، وكيلاً قوياً لإيران في جنوب شبه الجزيرة العربية، فهددت بهم السعودية ودول الخليج بشكل مباشر، وعملت بواسطتهم على التسبّب باضطراب واضح في خطوط الملاحة ونقل النفط في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأيضاً إرسال صواريخ ومسيّرات انتحارية ضدّ إسرائيل للحفاظ على صورة المقاومة.
في غزة، نشأت حركة حماس وهي حركة سنّية ذات خلفية إخوانية، في ظروف غير مستقرة، وكانت دائماً محاصَرة من إسرائيل والغرب وحتى من أنظمة عربية، فوجدت في إيران التي كانت تبحث عن أذرع غير شيعية لتُثبت أن مشروعها ليس طائفياً محضاً، السند والدعم والتمويل لتنشأ بين الطرفين علاقة تبادلية يحكمها براغماتية واضحة، تستفيد منها حماس عسكرياً ومالياً وإعلامياً، وتمتلك إيران بدورها ورقة ضغط قوية جعلها حاضرة في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هذه هي الصورة العامة للمنطقة، مشروع إيراني توسعي تسبّب في زعزعة الاستقرار الإقليمي وغيّب مفاهيم الدولة والسيادة والقانون بشكل كبير، فوّلدت الميليشيات والخلايا المسلحة الموالية لها، وأذكت الصراعات والخلافات الطائفية، وعطّلت مشاريع تسويات وأماني بقيام دولة فلسطينية ولو على مساحة صغيرة، وكانت سبباً أساسياً في أزمات إنسانية كبرى.
ولأن الجزاء من جنس العمل، فقد واجهت إيران، تحديات حقيقية وتحولات دولية حازمة وعقوبات أميركية شلّت اقتصادها، وأزمات حياتية واقتصادية خانقة وسط انقطاعات خطيرة في المياه والكهرباء والوقود، وانهيار مدوّي لعملة محلية خسرت نحو 90% من قيمتها أدت الى نقمة واحتجاجات شعبية داخلية واسعة.
ترنّح النفوذ الإيراني مع اجتياح إسرائيل لقطاع غزة والقضاء على عدد كبير من قيادات حماس، ثم شلّ الحركة العسكرية لحزب الله في لبنان وتدمير قيادته وأعداد كبيرة من مسؤوليه وعناصره، وفرض الانكفاء عليه من جنوب لبنان، وكذلك مع شنّ الولايات المتحدة غارات على مواقع حيوية للحوثيين في اليمن، ثم الواقعة الكبيرة بسقوط نظام حليفها وتابعها بشار الأسد، وانسحاب ميليشياتها الطائفية من كامل أراضي سوريا، ثم تعرّضت في عقر دارها لضربات إسرائيلية عنيفة واسعة النطاق دمّرت مرافق استراتيجية ومصانع ومنشآت نووية، وخسرت مجموعةً كبيرةً ومهمةً من قياداتها العسكرية وعلمائها النوويين.
لم تكد إيران تستفيق من هول كل هذه الأحداث والنكسات, حتى جاء قرار الحكومة اللبنانية الحازم باستعادة السيادة وقراري الحرب والسلم، وسحب السلاح من كافة الميليشيات بما فيها ذراع ايران الأقوى والأخطر أي حزب الله، وحصر القوة بيد الدولة، في ما يُشبه “لكمة قاسية في الوجه” الإيراني.
القرار اللبناني تردد صداه في العراق حيث ارتفعت دعوة من مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني إلى “حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها” داعياً السياسيين الى العمل “بجدّ لتحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار” وهو ما يُمكن اعتباره محضر اتهام لإيران بأنها سبب ما يعيشه العراق من وضع هشّ للدولة وفساد وتراجع في مختلف المجالات.
كل هذه الشواهد العاجلة تؤكد أن مشروع “تصدير الثورة” سلكَ حافة النهاية، وأن المنطقة تتجه ببطء وخطوات محسوبة وموزونة بميزان الذهب نحو استعادة مفهوم الدولة، وإغلاق ملفات الميليشيات المأجورة والسلاح غير الشرعي، والتعافي أيضاً من تجارب ونتائج تصدير الثورة الايرانية.
هل من كلمة أخرى؟ نعم، لأنه يجب التعامل بحذر مع هذه الشواهد والمؤشرات، لأن إيران وحسب منطق “المرونة البطولية” قد تتكيّف وتتعايش مع الضغوط والخسائر وفق نظرية الانتصارات الدائمة، وهي ما تزال تملك أوراقاً متناثرة في لبنان وفصائل موالية في العراق وميليشيات الحوثي في اليمن، قد تساهم في إطالة فترة صمودها، وربما قد تلجأ إلى أوراق خفية ومفاجئة من باب “عليّ وعلى أعدائي”، إلّا أن هذا لا يحجب أن النهاية المتوقعة هي انتهاء الظواهر الشاذة، وفرض حلول سياسية شاملة، وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
معلومات إضافية ومفصلة
محتوى شامل ومفصل لمساعدة محركات البحث في فهرسة هذه الصفحة بشكل أفضل.
مواضيع ذات صلة
- مقتل قائد بارز بالجيش الروسي في تفجير سيارة مفخخة
- مصل داء الكلب يفشل في علاج شاب عراقي وتُوفي بعد 40 يوما
- لماذا يواصل الأثرياء الخروج من بريطانيا؟
- لماذا تتجه تركيا لحظر إعلانات المراهنات؟
- لبنان ـ فيديو الميلاد بطرابلس وامتحان الهوية الوطنية
أسئلة شائعة
س: ما أهمية هذا المحتوى؟
ج: هذا المحتوى يوفر معلومات قيمة ومفصلة حول الموضوع المطروح.
س: كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات؟
ج: يمكن استخدام هذه المعلومات كمرجع موثوق في هذا المجال.