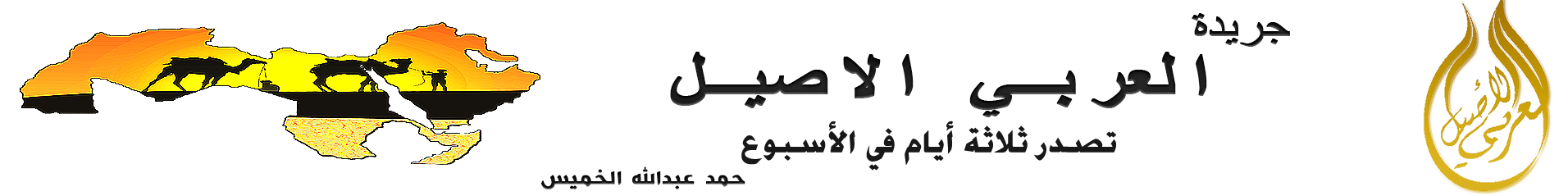سلاح حزب الله من وظيفة التحرير إلى البقاء الأبدي
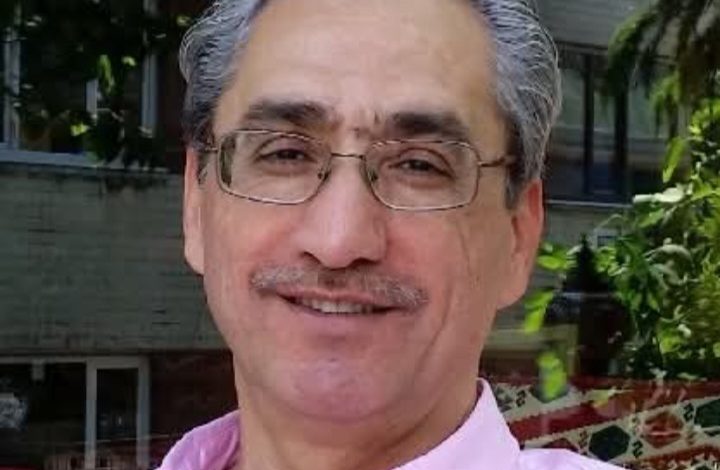
نبيل شحاده
تحوّل خطاب حزب الله منذ مطلع الألفية الثالثة، من الادعاء بأنه حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسلاحه دعامة أساسية لقوة وأمان لبنان، إلى مشروع سياسي وديني يتجاوز الحدود وينتقل إلى ساحات قريبة وبعيدة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت نفسه يُدخل البلاد في معادلات إقليمية وجدل عقائدي. ظهر ذلك بوضوح بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000، حيث كان اللبنانيون ينتظرون أن تُطوى صفحة “المقاومة المسلحة”، وأن يجد السلاح طريقه إلى مستودعات الجيش اللبناني، لتصبح الدولة وحدها – كما هو الحال في كل دول العالم – صاحبة القرار في السلم والحرب.
غير أن الحزب، بدل أن يعلن اكتمال مهمته وانتهاء وظيفته التي كلّف بها نفسه، بدأ في إعادة صياغة فلسفة وجوده وسلاحه، فحوّله تدريجياً من “سلاح تحرير” إلى “سلاح عقيدة”، ومن أداة ظرفية لها وظيفة معيّنة تخدم قضية طارئة، إلى رمز أبدي دون نهاية، مرتبط بغيبيات وأفكار دينية معقدة تدور حولها جدالات كبيرة، وتتعارض مع عقائد وإيمان غالبية اللبنانيين.
هذا التحوّل لم يأتِ عفوياً، ولا استيقظ له الحزب في عام 2000، بل كان نتيجة مسار فكري وسياسي بطيء وممنهج، عبّر عنه قادة الحزب سراً وعلانيةً في مناسبات عدة. ففي خطابات الأمين العام حسن نصر الله ومسؤولين آخرين، ظهر بوضوح هذا الانزياح من منطق سياسي ووطني يهدف إلى مكوّنات الشعب اللبناني ودغدغة مشاعر الرأي العام العربي، إلى خطاب ديني وعقائدي صرْف موجّه إلى بيئة الحزب والشيعة بشكل عام.
وتزايد الحديث عن “تحرير القدس وفلسطين كلها”، وربط الحزب بقضايا “المستضعفين”. ومع مرور الوقت، بدأ الحزب الترويج الواسع لمصطلحات أكثر التصاقاً بالعقيدة المهدوية مثل “محاربة الظلم والفساد على وجه الأرض، ونشر العدل ومنع الجور”. وتصاعد الخطاب بشكل خطير ومتسارع إلى ما سمعناه أخيراً من بعض الأطراف المرتبطة بفلك الحزب، من أن هذا السلاح ليس مجرد ترسانة عسكرية، بل هو “سلاح الأنبياء” و”سلاح الله”، وأنه “جزء من المشروع الإلهي” و”أمانة في أعناقنا لن نسلّمه إلّا إلى صاحب العصر والزمان”، أي المهدي المنتظر وفق العقيدة الشيعية الاثني عشرية.
خرج السلاح من إطاره الدنيوي المخصص لخدمة قضية ما أو لتحقيق إنجاز وطني، وأُعيد تسويقه على أنه جزء من “القدر” أو “المشيئة الإلهية”، مع وضع عوائق أمام أي إمكانية للنقاش أو التفاوض. فكيف تجرؤ الدولة، أو كيف يجرؤ الشعب اللبناني، على المطالبة بنزع “سلاح الله” أو “سلاح الأنبياء” أو “سلاح المهدي”؟
بهذه الصيغة الشائكة والغامضة، وضع الحزب نفسه وسلاحه في مرتبة تعلو على الوطن والدستور وكل الشعب اللبناني، وربما على البشرية جمعاء. واعتقد بذلك أنه يحصّن نفسه ويحمي سلاحه، ويجعل من المستحيل إخضاعه لمنطق الدولة وسلطتها وقوانينها.
لن نترك هذا السلاح جانباً
لقد ضرب حزب الله الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الدولة، الذي يستند – كما يعلم الجميع – إلى عقد اجتماعي ودستور مدني توافقي يضمن التعددية، ويحصر حق استخدام القوة المسلحة بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية. ففي مقدمة الدستور نجد أن لبنان “جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”. كما أن “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية وضع خريطة طريق صريحة تقضي بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من السلاح، لضمان عودة الدولة إلى موقعها كمرجعية وحيدة وبلا شريك.
غير أن حزب الله، مدعوماً من قوى إقليمية، تجاوز هذه النصوص واعتبر نفسه استثناءً وحيداً ودائماً بذريعة المقاومة. ومرّة يقول إن “المقاومة حاجة وطنية ما دام هناك تهديد إسرائيلي” و”معادلة الردع وتوازن الرعب”، ومرّة أخرى يحيل المسألة إلى “التكليف الشرعي” و”الالتزام الإلهي” و”أنا الله مكلفني”، بحيث أغلق أي باب أمام النقاش السياسي، وإن استُتِر بجلسات حوار مملة، ففجّرها وأنهى مفاعيلها لاحقاً بإشعال حرب تموز عام 2006.
هذا التناقض بين منطق الدولة ومنطق الحزب، والذي استمر لعقود، جعل لبنان يعيش ازدواجية خطيرة انعكست على كل مجالات الحياة: دولة لها دستور وجيش لا حول لها ولا قوة، وتخضع في أغلب الأحيان إلى حزب يملك جيشاً خاصاً به، ومؤسسات تنافس مؤسسات الدولة، ويحتكم إلى مرجعية دينية هي ولاية الفقيه في إيران.
منطق الحزب في تحويل سلاحه إلى عقيدة غيبية تجلّى بوضوح في تصريح أمينه العام السابق حسن نصر الله عام 2002، عندما قال: “لن نترك هذا السلاح جانباً ونتخلى عن هذه الإمكانية الإلهية العظيمة التي أعطانا الله إياها”. وهذا المنطق رسم عناوين مواجهة مباشرة مع مكوّنات طائفية أخرى – مسيحية وسنّية ودرزية – ترى في هذا الطرح تهديداً ليس لوجودها وتوازنها وأمنها فحسب، بل تعتبره أيضاً مصدر تهديد لبقاء الكيان اللبناني ذاته.
إذ كيف يمكن لطائفة واحدة أن تحتكر السلاح بذريعة “إلهية”، وتفرض هيمنتها على الدولة، وتحصن نفسها وأفعالها من أي مساءلة، فيما يُمنع على الآخرين حتى التفكير في امتلاك وسائل حماية خاصة بهم، أو الحلم بالعيش في دولة طبيعية؟ هذا الأمر عمل على تغذية النزعات الطائفية وتضخيمها، وأوجد شعوراً عميقاً بالغبن والإحباط وانعدام العدالة لدى هؤلاء الآخرين الذين ما زالوا يملكون ثقة كاملة بدولتهم ونظامهم، رغم كل التهاون والانهيار، ويرون أنه لا يمكن لأي دولة حديثة أن تقبل بوجود “سلاح ديني” ينافس مؤسساتها ويرفض الخضوع لقراراتها.
فالسلاح المرتبط بعقائد غيبية – كائناً مَن كان – لا يعترف بسلطة الدستور ولا بنصوص القانون، ولا يلتزم بقرارات المؤسسات، ولا يُبالي بتنوع الشعب الثقافي والديني والاجتماعي، ويتجرأ على اتهام كل من يُطالب بنزعه بالخيانة أو العمالة، بل ويهدد بالاقتصاص منه. وإذا كان الجيش اللبناني يأتمر بسلطة مجلس الوزراء ويخضع للمساءلة والمحاسبة عند الضرورة، فإن سلاح الحزب، أو كما يسميه “سلاح الله”، لا يخضع إلا لـ”الحكم الشرعي” الذي يحدده الفقيه أو القيادة الدينية في إيران، وهذه معضلة مستمرة بلا نهاية.
الجديد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان أن المواجهة لم تعد محصورة بين غالبية الشعب اللبناني والحزب وسلاحه، بل أصبحت الدولة، وبما تمثله من شرعية ومرجعية متكئة على دعم كبير من المجتمعين العربي والدولي، تتقدّم بشجاعة إلى الخطوط الأمامية لممارسة دورها الطبيعي في معركة سحب السلاح واستعادة السيادة من سارقيها. هذا التحوّل غيّر قواعد اللعبة؛ فالمواجهة لم تعد سجالاً داخلياً، بل باتت صراعاً بين مشروع الدولة، التي يبدو أنها لا تريد أن تخسر الفرصة، ومشروع الدويلة.
وتكشف تفاصيل الصراع بين اللبنانيين، الذين أجمع غالبية ساحقة منهم على رفض السلاح غير الشرعي، وتعبوا من سطوته على السياسة والاقتصاد والأمن، وهم يطمحون إلى طمأنينة وطنية شاملة تقوم على قناعة بأن الدولة وحدها هي الضامنة لحقوقهم وحريتهم ووجودهم، وبين فئة قليلة لا تزال تتغذى على أحلام الماضي وتصرّ على البقاء خارج الحاضر والمستقبل. إن إعادة احتكار القوة بيد الدولة – سلماً أو حرباً – ليست إجراءً تقنياً عابراً، بل هي إعادة الاعتبار لفكرة الوطن نفسه، ومعنى وجود لبنان الذي تاه طويلاً ودفع الأثمان الهائلة، وحان وقت خروجه من حالة “الاستثناء” المدمّر، والقضاء على مصطلحات “الدويلة” و”المربّع الأمني” والمشروع الإقليمي.
معلومات إضافية ومفصلة
محتوى شامل ومفصل لمساعدة محركات البحث في فهرسة هذه الصفحة بشكل أفضل.
مواضيع ذات صلة
- وزير النقل التركي: ندعم كل خطوة لإعادة إعمار سوريا
- مادور يتحدى أمريكا.. تحضير للإعلان عن خطة فنزويلا الدفاعية الجديدة
- ما دلالات صلاة الشرع في المسجد الأموي بذكرى التحرير؟
- كيف انتهت حكاية سجون عائلة الأسد؟
- قلق في إسرائيل من هتافات جنود سوريين لغزة
أسئلة شائعة
س: ما أهمية هذا المحتوى؟
ج: هذا المحتوى يوفر معلومات قيمة ومفصلة حول الموضوع المطروح.
س: كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات؟
ج: يمكن استخدام هذه المعلومات كمرجع موثوق في هذا المجال.